Read in:
لا سبب هنالك للكتابة قبالة ما تتضمّنه الحياة؛ هكذا يبدو الأمر في الساعة الثامنة وتسعٍ وعشرين دقيقة صباحًا من منتصف يوليو، 2014.
رام الله، وسط البلد، الطابق الخامس. يرن الهاتف ويظهر رقم المتّصل على الشاشة. إنه ليس لأحد معارفنا، فالرقم غير معروف. مع ذلك، يتطلّبُ اتصال هاتفي في ساعة مبكِّرةٍ كهذه الردَّ عليه.
في الحقيقة، أنا لا أحب الهواتف النقّالة البتّة. إحدى صديقاتي وهبته لي حال وصولنا، أنا وعائلتي، إلى رام الله ليكون لدينا وسيلة اتصالٍ مع العالم في حالات الطوارئ، كهذه الحالة كما يبدو، التي يُقْدِم فيها أحدهم على الاتصال بنا في مثل هذا الوقت من الصباح. مع ذلك، أبقى وفيّة لعدم حبي للهواتف النقّالة، وأتنصّل من كل مسؤولية تتعلّق به. لذا، عندما يرنّ في الساعة الثامنة وتسعٍ وعشرين دقيقة، أتركه يواصل الرّنين حتى يجيب زوجي. وهو، بدل أن يباشر الحديث، يلتزم الصمت. ثم يحوِّل الهاتف إليّ ويلصقه بأذني اليسرى. إنّها رسالة مسجّلة يتلوها صوت جهوري. رجل يتحدّث العربية الفصحى. أنجح بسماع هذا الجزء فقط ممّا يقول: “وأُعذِر من أنذر. جيش الدفاع الإسرائيلي”. تنتهي الرسالة وينقطع الخط، وأجمد أنا مكاني.
إن هذا النوع من الاتّصال يقوم به الجيش الإسرائيلي قبل قصفه مبنىً سكنيًّا ما لتحذير سكّانه والقاطنين قربه، وبذلك يحصّن الجيش نفسه قانونيًا من دعوات قضائية مستقبلية محتملة. ففي اللحظة التي يجيب فيها أحدهم على الاتّصال، لا يعود بالإمكان اتّهام الجيش بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية، فقد “أُعذِر من أنذر.” وقد يجري القصف خلال نصف ساعة من لحظة الاتّصال. قبلها بيوم فقط سمعت عن شابّ من غزة تلقّى مكالمة تحذيرية كهذه يعلمه فيها الجيش الإسرائيلي بأنّه سيقصف المبنى الذي يقطنه الشابّ مع عائلته في شمال غزة. كان هذا الشابّ لحظتها متواجدًا في مكان عمله في جنوب غزة، فراح يحاول بدوره الاتّصال بعائلته لإنذارهم. ولكن دون جدوى. لم يجب اتصالَه أحد؛ فمن عادة الناس في شهر رمضان، كما كان الحال آنها، أن يسهروا في الليل ويناموا حتى ساعة متأخرة من النهار. لكنّ فزع الشابّ كان أقوى من أن ينسى أمر هذه المكالمة، فترك عمله واتّجه في الحال نحو البيت، عدا أنه لدى وصوله وجده قد دُمِّر في قصف جوّي، فيما قضى بعض أفراد عائلته نحْبَهم وجُرِح آخرون.
لا أعرف إن كانت هذه الحادثة قد جرت فعلًا، فكثيرًا ما يسمع المرء في مثل هذه الظروف حكايا، لشدّة قسوتها، يميل لعدم تصديقها. غير أنّه في الساعة الثامنة وتسعٍ وعشرين دقيقة صباحًا من منتصف يوليو 2014، تنقضّ عليّ تلك الحكاية لتمثل أمامي كمصيري. فأنا لا أعرف لمن يعود الهاتف الذي بحوزتي بالأصل، أو لمن يعتقد الجيش الإسرائيلي أنّه يعود بالضبط. أفكر في صديقتي التي منحتني إيّاه واحتمال انتمائها لحركة سياسية ما. أشكّ بذلك. ثم أنصرف أفكر في جيراني. أجرُدُ بسرعة سكّان العمارة والحيّ ممن التقيتهم خلال الأسبوعين الماضيين منذ وصولنا من برلين، وأحاول أن أحزر أيّ منهم قد يكون مطلوبًا لقوات الاحتلال. كلّ من صادفتُ حتى تلك اللحظة هم أطفال مزعجين تتراوح أعمارهم بين الرابعة والحادية عشرة، وسيدتان وامرأة مسنة، إضافة إلى رجل في نهاية الخمسينيّات من عمره، ما لا يطمئنني. فسماتهم جميعًا لا تختلف البتّة عن نوع الضحايا الذي تعلن الأخبار عن مقتلهم كلّ بضع ساعات من الهجوم وقتها على غزة. ثم أتنبّه فجأة إلى نفسي عقبَ جردي هذا للجيران. لقد تحوّلت في لمح البصر، خوفاً على عائلتي وعلى نفسي، إلى أشبه ما يكون بضابط جيش إسرائيلي يدرس مَن مِن الفلسطينيين يشكِّل “مصدرًا للخطر على أمنه”.
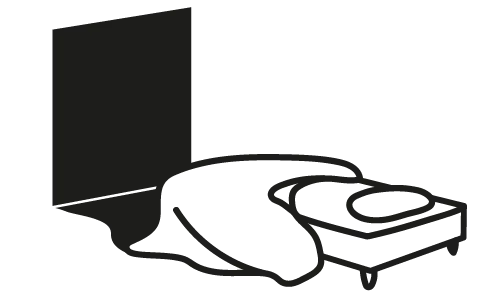
زوجي ما زال واقفًا أمامي، كما وقفت خلفه ابنتنا ذات الثمانية أعوام، بينما يرقد طفلنا ذو الثلاثة أشهر نائمًا في الغرفة الثانية. يسألني زوجي عن المتّصل وفحوى الرسالة المسجّلة، فمعرفته باللغة العربية محدودة. أنظر إليه ثمّ إلى ابنتنا الفضولية. أحاول أن أعثر على ما يمكنني أن أتفوّه به، لكنّ إحساسًا بالوهن يغلبني. لا أعرف ماذا أقول. الكلمات تُعرض عني. أتركهما، واتّجه إلى طفلنا ذي الثلاثة أشهر، بعد أن أطلب من ابنتنا تجهيز نفسها، لأنّ علينا مغادرة البيت خلال نصف ساعة. هي عليها أن تلتحق بالمخيم الصيفي، وأنا عليّ الذهاب إلى الجامعة. لا يمكنني أن أتأخر عن طلابي الذين من أجلهم تركنا برلين وحضرنا إلى رام الله. في برلين، لم يكن بمقدوري أكثر تحمّل الوحدة القاسية الموجّهة نحو العالم، التي تَلُفّ فعل الكتابة: أن أجلس وحدي وأكتب، فيما يواصل العالم خرابه. أجل ربما أكتب أحيانًا مندفعة بقوة ما أشهد من هذا الخراب، لكن غالبًا دون إحداث تغيير ما في مجرى الحياة، وعلى رأسها حياتي الذاتية. لذلك أقرر هجر الكتابة وأتجه عائدة إلى فلسطين. على الأقل من وقت لآخر. فكلّما ازداد البؤس في العالم، بدا أنّ أشدّ ما يمكن لحرفة الكتابة أن تتقن فعله بامتياز هو العزلة، فيما اتقان الكلمات نفسها يزداد صعوبة. بدل ذلك، أقوم بالالتحاق بجامعة بير زيت كمحاضرة زائرة، أدرِّس طلّابًا في العشرينيات من عمرهم، غالبيتهم بذلوا قصارى جهدهم كي يتمكّنوا من الانتساب إلى الجامعة، قادمين من أنحاء مختلفة من فلسطين التى ما عاد يمكن التنقّل عبرها بسهولة أيضاً. ففي أعقاب تشييد عشرات الحواجز، وبناء الجدار، إضافة إلى منع المركبات الفلسطينية من السفر فوق العديد من الشوارع، صار البُعد بين الكثير من المناطق أضعافَ ما كان عليه في السابق. أصبحت القدس التي تبعد نصف ساعة عن بير زيت، تبعد ساعتين، والخليل التي تبعد ساعة، صارت تبعد أربع ساعات. وفي ظلّ هذه الظروف باتت الجامعة المكان الوحيد الذي يمكن لهؤلاء الشباب من اللقاء به معًا، بل والاحتماء فيه، لعدّة أعوام على الأقل، من اضطهاد الحياة لهم وإنهاكها لعقولهم ورغباتهم وحماستهم.
لكن مع ذلك، الحياة خارج نطاق الجامعة، وإن وددنا أو حتى قرّرنا تجاهُلها، تعود وتقتحم الحصص بعنف. لا يمكن الحديث أمام هؤلاء الطلاب حول أي موضوع أو نقاش فكرة ما، دون أن تتداخل بها تجاربهم الحياتية والظروف القاسية التي لا يملك أيّ منهم القدرة على النجاة منها. فحين نتحدّث عن مفهوم الحرية في العصر الحديث، يطغى علينا عدمُ الحرية الذي يرزخون تحته، إذ سيتغيّب بعضهم عن الحصص بسبب اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال، أو لأن أحدهم سيرقد في المستشفى لأسابيع عديدة بعد إطلاق النار عليه خلال مسيرة ضد الممارسات الإسرائيلية.
أعود لأنظر إلى الرقم الذي جرى الاتصال منه. يمكنني الضغط على زر واحد فقط لأعود وأتّصل بـ”جيش الدفاع الإسرائيلي.” على الأقل أعترض على القصف الذي يَعِد به. أو بإمكاني أن أبعث له رسالةً نصية. لكن حين أفكر بما عساي أن أقول أو أن أكتب، يشلّني إحساس بالخدر إثر تيقّني بأن الكلمات التي ستتدفّق مني ستكون بغير فائدة. وتروح قسوة هذا الإدراك بعدم تماسك الكلمات وبأنه لا حول لها حينما أكون بأمسِّ الحاجة إليها، تسحقني.
فبينما الآن بات بإمكان الجيش الإسرائيلي أن يتصل بك شخصيًّا على هاتفك ليعلمك أنه قد يقصف بيتك، أو بيوت الآخرين، أنت لن تتمكّن من قول شيء. لحظة أخرى تضاف على الكثير من اللحظات التي يجابهها المرء، حين يدرك، ما يُرْتَكب من جرائم في أنحاء شتى من العالم، تصبح إثرها العينان سجينتي ما تشاهدانه، والجسمُ الحدَ الذي لا يمكن تجاوزه، بينما الفم أبكم.
وأمام عادية هذا البؤس تعود حرفة الكتابة لتبدو أكثر حرفةً لا مكان لها في عصرنا، تماماً مثل حرفة مُضيئي المصابيح الزيتية في الشوارع.
أنظر إلى زوجي ثم إلى طفلي ذي الثلاثة أشهر، وأغادر البيت بصحبة ابنتي. هل ستكون هذه آخر مرة أراهما فيها؟

Walter Benjamin’s
streetlamps
Walter Benjamin’s streetlamps

Winterabend
Manchmal nahm mich an Winterabenden meine Mutter zum Kaufmann mit. Es war ein dunkles, unbekanntes Berlin, das sich im Gaslicht vor mir ausbreitete. Wir blieben im alten Westen, dessen Straßenzüge einträchtiger und anspruchsloser warn als die später bevorzugten. Die Erker und Säulen gewahrte man nicht mehr deutlich, und in die Fassaden war Licht getreten. Lag es an den Mullgardinen, den Stores oder dem Gasstrumpf unter der Hängelampe dies Licht verriet von den erleuchteten Zimmern wenig. Es hatte es nur mit sich selbst zu tun. Es zog mich an und machte mich nachdenklich. Das tut es in der Erinnerung heute noch. Dabei geleitet es mich am liebsten zu einer von meinen Ansichtskarten. Sie stellte einen berliner Platz dar. Die Häuser, die ihn umgaben, waren von zartem Blau, der nächtliche Himmel, an dem der Mond stand, von dunklerem. Der Mond und die sämtlichen Fenster warn in der blauen Kartonschicht ausgespart. Sie wollten gegen die Lampe gehalten werden, dann brach in gelber Schein aus den Wolken und Fensterreihen. Ich kannte die abgebildete Gegend nicht. »Hallesches Tor« stand darunter. Tor und Halle traten in ihr zusammen und bildeten die erhellte Grotte, in welcher ich die Erinnerung an das winterliche Berlin vorfinde.
Walter Benjamin, Berliner Kindheit um 1900 (Suhrkamp, 1987)
Winter Evening
Sometimes, on winter evenings, my mother would take me shopping with her. It was a dark, unknown Berlin that spread out before me in the gaslight. We would remain within the Old West district, whose streets were more harmonious and unassuming than those favored later. The alcoves and pillars could no longer be clearly discerned, and the faces of the houses shone with light. Whether because of the muslin curtains, the blinds, or the gas mantle under the hanging lamp-this light be-trayed little of the rooms it lit. It had to do only with itself. It attracted me and made me pensive. It still does so today, in memory. Thus it leads me back to one of my picture postcards. This card displayed a square in Berlin. The surrounding houses were of pale blue; the night sky, dominated by the moon, was of darker blue. The spaces for the moon and all the windows had been left blank in the blue cardboard. You had to hold it up to a lamp, and then a yellow radiance broke from the clouds and the rows of windows. I was not familiar with the neighborhood pictured. «Halle Gate» was inscribed at the bottom Gate and hall converged in this image, and formed that illuminated grotto where I meet with the memory of a wintry Berlin.
Walter Benjamin, Berlin Childhood around 1900, translated by Howard Eiland (Harvard University Press, 2006)
برلين. الساعة الواحدة ظهراً. يحتبس البرد داخل مقطورة القطار التي تنتشر المعاطف الشتويّة السوداء في كل صوب منها كثقوب، فيما الأنظار تحاذر ألا يقاطع بعضها البعض، خوفاً من حميمية قد تفضح الإحساس العام بالعزلة. أمامي تقف سيدة تحدِّق في عتمة النفق التي أشرفت عليها نافذة المقطورة. إلى يمينها عربة أطفال يجلس فيها طفل يبلغ العامين على الأغلب، يحدِّق بدوره في المسافرين حوله. من حين إلى آخر، تدفع السيدة بفتات الخبز الأبيض إلى فم الطفل بصمت. وفجأة ينقضّ عليّ الإحساس ذاته بالعجز الذي انتابني في رام الله القابعة تحت الاحتلال، هنا في برلين الحرّة، حيث الحزن والبؤس يلفّ الخبز الأبيض في يد تلك المرأة الساهمة في عتمة النفق. في بلد يقال بأنه الأكثر أمانًا اقتصاديًا في العالم، وإليه يحاول اللجوء آلاف المنكوبين، الكثير ليس على ما يرام بطبيعية شديدة.
ثمّ في الساعة الواحدة وخمسٍ وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل، يصحّيني الأرق على عتمة حالكة في الغرفة. أبقى ساهمة في الحائط، الذي ألحظ فوقه بعد وقت، رسمًا مكعّبًا شديد الاسوداد. الرسم غريب، وإذ لا أفقه سبب وجوده على الحائط، ينتابني الذعر. إنني متأكدة بأن الحائط أبيض، ولا يمكن أن يكون جزء منه قد اسودّ فجأة. تستمرّ الحيرة المصبّغة بالخوف بامتلاكي، فيما آخذ بالدوران في أنحاء الغرفة بحثًا عن مكعبات مظلمة أخرى قد تكون داهمتها خلال نومي، إلى أن أنتبه أخيرًا إلى كومة الكتب التي استلقت على حافة النافذة. كان الضوء الواهن القادم من الخارج من مصابيح الشارع، قد ألقى بظلّ الكتب على الحائط المقابل، ليتشكَّل فوقه ذلك الرسم المكعّب الضخم.
ربما الكلمات هي كذلك، على صغرها تترك في العالم أثرًا ما، على غرار هذا الضوء الضئيل المنبعث من مصابيح برلين القديمة، الذي يترك أثره بهدوء خلسة، مانحًا في تلك الساعة المتأخرة من الليل، درسًا أساسيًا في تعلّم الكتابة من جديد.